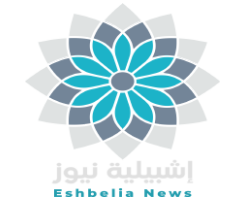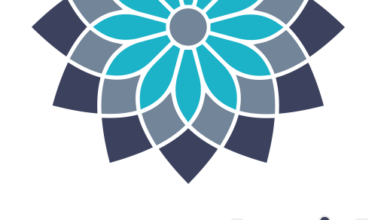الفضيلة (Virtue ) ..
بمفهومها الثابت و المتبدل ..
د.علي أحمد جديد
يمكن الإجماع على تعريف (الفضيلة) بأنها الخلق الطيب .. والخلق هو “التعوّد بالإرادة” ، لأنه إذا اعتادت الإرادة شيئاً طيباً صارت هذه العادة (فضيلة) . والإنسان الفاضل هو ذو الخلق الطيب الذي تعوّد اختيار ما تأمر به الأخلاق ، وبذلك يمكن التفريق بين الفضيلة وبين الواجب بوضوح ، إذ أن (الفضيلة) صفة نفسية وذاتية تلتزم الأخلاق ، بينما يكون الواجب عملاً خارجياً يستوجب القيام به وتأديته ضمن شروطه المحدَّدة . وعلى هذا يكون الواجب عملاً مشروطاً وتكون الفضيلة سلوكاً أخلاقياً متحرراً من أي شرط .
ويمكن ان تكون (الفضيلة) هي العمل نفسه وحتى يمكنها أن تكون واحدة من “فضائل الأعمال” ، ولكن ذلك لا يشمل كل عمل أخلاقي وإنما يشمل الأعمال العظيمة التي يستحق فاعلها الشكر والمديح والثناء .
وتختلف قيمة الفضيلة لدى الأمم اختلافاً كبيراً ، ولكل أمّة قائمة تتضمن الفضائل تختلف عند أمّة أخرى ، لأن ترتيب الفضائل في كل أمّة يتبع مركزها الإجتماعي والظروف المحيطة بها والبيئة الأخلاقية فيها ، ويأتي ترتيب الفضائل في الأمّة المحكومة مختلفاً عن الترتيب في الأمّة المتسلطة .. إذ أن الأمّة المحاصرة و المهددة بالحروب تكون الشجاعة لديها أهم فضيلة ، بينما ترى الأمّة الآمنة المطمئنة أن العدل هو خير فضيلة .
كما يختلف مفهوم الفضيلة باختلاف العصور ، فما كان معروفاً عن الشجاعة عند الاغريق في تاريخها القديم هو غيره اليوم لدى الدولة اليونانية الحديثة ، فقد كانت فضيلة
الشجاعة لديهم في السابق تعني الصبر على تحمل الآلام الجسمية ، ولكنها اليوم تشمل تعبير الإنسان عن رأيه بكل حرية دون خشية مَن حوله .
وكذلك هو العدل الذي تطور مفهومه بتطورات الأمم في حالتها العقلية والإجتماعية . فالإحسان إلى الفرد بالتصدق عليه كان من أهم الفضائل في القرون الوسطى ، وصار موضع نقدٍ وازدراء في العصور الحديثة ، لأنه لا تمييز فيه بين المستحِق للإحسان وبين غير المستحِق تمييزاً يمكن الوثوق أو الاقتناع به ، لأنه يثبط من همّة مُتلَقي الاحسان إليه ويقعد به عن العمل . وقد استحدث المحسنون إنشاء الجمعيات الخيرية للإحسان التي تجمع التبرعات من الأفراد لتتولى إداراتها الإنفاق على المعوزين بعد دراسة حالاتهم والتعرّف إلى حقيقة فقرهم الذي يدّعون . ولا تكتفي هذه الجمعيات بإعطاء المال إلى المحتاجين ، بل باتت تسعى لإيجاد العمل لمن لا عمل له ، وتنقذ أولاد البائسين من آبائهم حتى لا ينشأوا نشأتهم .. وأوجدت المدراس الصناعية لتعلمهم العلوم العملية والحِرَفية حتى لا يكونوا عالة على المجتمعات . وقد اهتمت الأمم بإنشاء الجمعيات ، ومنعت إحسان الفرد للفرد ، في الوقت الذي تحضُّ على إحسان الفرد للجمعيات حصراً .
وذلك ما غيّر من مفاهيم الفضائل بعد التدخل فيها وتهذيبها لتتناسب والعقل الحديث بالتقدم المدني والاجتماعي الذي يطرأ على كل أمّةٍ من الأمم .
كما تختلف أيضاً قيمة الفضائل باختلاف حالة الأفراد الاجتماعية وأعمالهم ، ففضيلة الكرم – مثلاَ – بالنسبة للفقير ليست بذات الأهمية بالنسبة للغني ، ولا الفضائل الضرورية للمسن التي تشكل الضرورة القصوى بالنسبة للشاب ، ولا يمكن ترتيب فضائل المرأة كترتيب فضائل الرجل ، ولا فضائل التاجر هي نفسها فضائل العالِم والباحث … وهكذا .
ومن الصعوبة على الأعراف الأخلاقية باختلافها التعمق في التفصيلات وبيان الإختلافات الدقيقة بين الأشخاص والتي يترتب عليها اختلافٌ في قيمة الفضيلة نفسها .
وكل مايمكن قوله أن الناس جميعاً — مهما اختلفوا — مطالبون بفضائل عامة من صدق وعدل ونحوهما ويجب أن يتصفوا بها ، وأنهم على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم العلمية والإجتماعية يستوون في شيء واحد ، وهو أن كلاً منهم مطالب بأن تكون فضائله تناسب حالته وأن تتفق مع مركزه الإجتماعي وعمله الذى يؤديه مهما اختلفت البيئة الأخلاقية في تطبيق ذلك .
كما يمكن أن تكون الفضائل أكثر شمولية ، كالأمانة التي تدخل في مفهوم العدل .. والقناعة التي تدخل تحت مظلة العِفّة .
فالفضيلة في مذهب “سقراط” الذي يرى أن “لا فضيلة إلا المعرفة” ، لأنه يرى بأن معرفة الإنسان للخير وللشر تكفي وحدها لعمل الخير وتجنب الشر ، وأن إقدام الإنسان على الشر ليس له من سبب إلا الجهل بنتائجه ، ولو علم الإنسان نتائج الشر علماً جازماً وصحيحاً لما أقدم عليه ، وأن كل الشرور ناشئة من الجهل . وكذلك لو علم المرء أين الخير لعمله حتماً ، وعلل ذلك بأن كل فرد بطبيعته وبفطرته الإنسانية يقصد الخير لنفسه ويكره لها الشر ، ومن المحال أن يفعل ما يضرها وهو عالم بضرره . وما يصدر عن إنسان من الخطأ إنما منشأُه الجهل بما يعقب العمل من نتائج أو الشك فيها ، وعلاج الشرير تعليمه وتنويره لمعرفة نتائج الأعمال السيئة التي تصدر عنه تعلماً صحيحاً . ولتعويد فردٍ ما الخير وجعله مصدراً للفضيلة تجب معرفته بنتائج الأعمال الحسنة .
وكثيراً ما يعلم الفرد الخير ويتجنبه ، ويعلم الشر فيأتيه ، وبذلك تكون معرفة الخير غير كافية في الحَملِ على فعله ، بل لا بد أن تنضم إلى المعرفة إرادة قوية تتيح للفرد عمل ما يعرف من العلم .
ولكن في رأي “سقراط” أنه ليست هناك في الحقيقة إلا فضيلة واحدة وهي “المعرفة” أو مايمكن تسميتها “الحكمة” ، وماغيرها من الفضائل كالشجاعة والعِفّة والعدل إلا مظهرٌ من مظاهر المعرفة وصادرٌ عنها .
بينما يرى (أفلاطون) أن في الإنسان قوتين اثنتين إذا اعتدلتا نشأت عنهما الفضائل ، وهما :
* – قوة العقل ، والتي إذا إعتدلت نشأت عنها فضيلة الحكمة .
* – قوة الغضب ، وهي التي إذا إعتدلت نشأت عنها الشجاعة .
بينما يقول فيلسوف القبالة اليهودية (سبينوزا) عن”الفضيلة” بأنها القدرة والاستطاعة على كيفية التصرف والفعل ، ويقصد بذلك “القدرة” أي قدرة الفرد على ذاته ، لأنه كلما ازداد الإنسان سعياً وراء ما فيه من فائدة العيش والبقاء ازدادت متعته بالفضيلة ، وبذل أضعاف الجهد للمحافظة على بقاء النفس ، وذلك هو الأصل الوحيد للفضيلة .
وقد أجمعت الفلسفات في أغلبها على فهم الفضيلة بعمق ، وعلى بيان فوائدها لتعمَّ الفرد والمجتمع ، وبيان علاقتها الوطيدة بالقيم الأساسية والأصيلة الثلاث التي تنحصر في :
(الحق والخير والجمال) وهو ما يظهِر الفضيلة بأبهى صورها و فوائدها .
وإن الفضيلة سمة لا تتغير ، وحقيقة لا تتبدل ، لأن الصدق لا تتحول في معناه المنافع ولا تؤثر فيه المغريات ، والوفاء هو نفسه الوفاء مهما اختلفت صوره وظروفه . وكذلك هي فضائل العدل والعفو والإحسان ، كل هذه من الفضائل المستقرة والثابتة ، لايمكن أن تغيّرها الظروف .
أما اليوم فقد كان لتأثير الماديات على الفكر الفلسفي ، ولسيطرة العصبيات الجنسية ، والنعرات المذهبية والطائفية والعرقية الإثنية ، الدور الكبير في تغيير وتبديل المفهوم العلمي والحقيقي لمصطلح (الفضيلة) وصارت لها أسماء ومعاني مغايرة ، فباتت :
– “القوة” فضيلة بدل الرحمة ..
– و”الظلم” فضيلة في محل العدل ..
– و”الاستعباد” فضيلة مُثلى بدل الحرية والاختيار .
– و” الفساد ” مرجعية الفضائل المتداولَة والتي يتم ممارستها كلها .