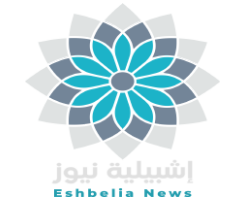فلاسفة “التنوير” و”الحرية”..
ألبير كامو ..
د.علي أحمد جديد
معروف أن الفلسفة هي الاحتكام العميق للعقل ، والإيمان بحرية التعبير ونبذ العنف بكل أشكاله المادية والرمزية ..
فكيف يمكن لبعض الفلاسفة أن يتغاضوا عن الظلم ، وعن تعمّد ارتكاب الأخطاء والشرور ، بل والحرص على شَرْعَنَتِها وتبريرها حَتى؟!!..
وهل يمكن تخليصهم من لا شعورهم الفطري بالعنصرية الاستعمارية ؟..
في العام 1940 انضمّ الفيلسوف والكاتب الفرنسي (جون بول سارتر) إلى الجيش الفرنسي ، وتمَّ احتجازه لفترة وجيزة في معسكرات أسرى الحرب النازية ، حتى هروبه منها .
وقد شكل تحرير باريس عام 1944 من النازيين والهزيمة اللاحقة بالجيوش الألمانية في أوروبا ، أرضيةً لظهور ما أطلقوا عليه “الفلسفة الوجودية” على اعتبارها أنها “فلسفة حرية” بامتياز انطلاقاً من (جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار) .
في مقالات (سارتر) بعد الحرب ، كان يحثّ المثقفين على الالتزام والعمل لبناء صرح “أدب” ملتزم سياسياً . وانبهر المثقفون العرب من مواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي للجزائر ، ومهاجمته التصرفات الإمبريالية في كوبا وأميركا اللاتينية ، وفي فيتنام ، علاوة على رفضه غير المسبوق لجائزة نوبل للآداب في عام 1964.
وقبل شهر من نكسة حرب حزيران/يونيو 1967 وقّع (جان بول سارتر و سيمون دو بوفوار) إلى جانب العديد من المثقفين الفرنسيين بياناً يدعون فيه الشعب الفرنسي إلى دعم “إسرائيل” على اعتبار أنها “الدولة الوحيدة التي يتمّ التشكيك بحقها الإنساني في الوجود ، والمهدّدة من محيطها العربي المتخلّف . لأنه في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي كان دعم (سارتر و دو بوفوار) صريحاً لإقامة دولة يهودية ، ذلك لأن اليسار الفرنسي عموماً كان متعاطفاً مع “الاتحاد السوفياتي” الذي كان بدوره الداعم الأول في مجلس الأمن الدولي من هيئة الأمم المتحدة لقيام دولة “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية واعترافه بها ، وكان (سارتر) يجاهر بدعمه الصريح للصهيونية إثر محاكمة تلميذه (روبرت مزراحي) بتهمة بشراء أسلحة لصالح منظمة “شتيرن” الإرهابية الصهيونية التي تقوم بأعمالها الإرهابية على أرض فلسطين للتخلّص من سكانها العرب ويومها قال تصريحه الشهير :
“أعتبر أن واجب غير اليهود هو مساعدة اليهود في فلسطين” .
وبشكل صريح رفض اعتبار “إسرائيل” أمّة إمبريالية ، حيث تابع :
“أعتقد أنه من غير المفهوم تحديد هوية إسرائيل بكونها ضمن معسكر إمبريالي وعدواني” .
متجاهلاً أن سلوك الإبادة الصهيونية للفلسطينيين كأساس لإقامة الدولة اليهودية على أرضهم هو نفس السلوك الامبريالي في إقامة الولايات المتحدة الأمريكية بعد إبادة 112 مليون من الهنود الحمر السكان الأصليين في الشمال الأمريكي . وقد شكّل ذلك خيانة كبرى للقضية الفلسطينية ، حيث تمّ الطلاق بين (سارتر) وبين بعض المثقّفين العرب ، بسبب موقفه من “الصراع” العربي – الإسرائيلي في الفترة من 1967 إلى 1980 مقارنة بما كان عليه من قبل . وكردِّ فعل على دعم (سارتر) الصريح للكيان الصهيوني ، طلبت أرملة فرانز فانون (1925 – 1961) من ناشري كتاب زوجها “المُعذّبون فِي الأرض”حذف مقدمة (سارتر) من جميع الطبعات المقبلة للكتاب .
وكذلك كان “الفيلسوف التنويري”
(ألبير كامو) عندما عارض في السنوات الأخيرة من حياته و بشكل علني وعنيف ، المطلب القومي باستقلال الجزائر ، لأن معارضته كانت بالتصوّر الذي سبق أن قدّمه عن الجزائر منذ بداية مسيرته الأدبية .
ففي رواياته وأعماله قدّم (البير كامو) الوجود الفرنسي في الجزائر ، كموضوع شرعي وسردي خارجي ، وباعتباره القصة الوحيدة التي تستحق أن تُروى كقصة وليس باعتباره احتلالاً غاشماً . حيث قال :
“لم تكن هناك أبداً أمّة جزائرية بعد . سيكون لليهود والأتراك واليونانيين والإيطاليين والأمازيغ نفس القدر من الحق في المطالبة باتجاه هذه الأمّة الافتراضية . لأن العرب لايشكّلون وحدهم كل الجزائر . وإن حجم و عمر المستوطنة الفرنسية ، على وجه الخصوص ، كافيان لخلق مشكلة لا يمكن مقارنتها بأيّ شيء في التاريخ . الفرنسيون في الجزائر هم أيضاً ، بالمعنى القوي للكلمة ، مواطنون . ويجب أن نضيف أن جَزَائِرَ عربية بحتة لا تستطيع أن تحقّق الاستقلال الاقتصادي الذي من دونه سيكون الاستقلال السياسي مجرّد خدعة” .
ولم يكن (البير كامو) يحبّ جزائر الجزائريين ، بل جزائر الأقدام السوداء والمعمّرين . أي الجزائر التابعة للمحتل الفرنسي . كما يقول الكاتب الجزائري (رشيد بو جدرة).
وتتخلّل “أدب الفلسفة التنويرية” – كما يحبون تسميته – مفارقة صارخة تتمثّل في تجذّر أفكار الحرية الإنسانية والحقوق الفردية في الدول التي تستعبد البشر ، والتي تقوم بالموازاة مع ذلك على إبادة السكان الأصليين كأساسٍ اجتماعي في نشوء الكيان المحتل . وقد سارت الهيمنة الاستعمارية والاحتلال جنباً إلى جنب مع انتشار “الليبرالية” ومع المفاهيم الحديثة عن العرق والعنصرية . فكشفت هذه المفارقة عن الوجه العنصري الخفيّ لادّعاءات “التنوير” الذي يتمّ الحديث عنه في الفكر الثقافي العربي بانبهار واندهاش . ولهذا فقد تطوّرت العنصرية في الساحات الثقافية العربية على أساس اعتبارها “نظاماً اجتماعياً سياسياً قائماً على تراتبية هرمية دائمة لمجموعات عرقية وإثنية معينة” وكان ذلك كمحاولة لحلّ التناقض الأساسي بين الاعتراف بالحرية وبين التمسّك بالعِرق .
وتدعم هذه المسيرة “التنويرية” المشتركة لليبرالية ولتفوّق العرق الأبيض – سواء كان “عَقْد لوك الاجتماعي” أو “نظرية (كانْت) الأخلاقية” – فكرة “العَقْد العنصري” الضمني الذي يدعم مشروع الاحتلال “التنويري” . حيث يؤسّس العَقْد العنصري نظام حكم عنصري ودولة عرقية ، ونظاماً قضائياً عرقياً يتم بموجبه تحديد وضع “البيض” وباقي الأعراق الأخرى بوضوح ، سواء بموجب القانون أو العرف كما كان وضع “جنوب افريقيا” سابقاً .
وقد بلور (جون لوك) في كتابه “مقالة في الفهم الإنساني” فهماً جيّداً للإنسان من خلال استثمار مدخّراته بشراء مجموعة من الأسهم في شركة “رويال أفريكان” التي كانت تصطاد وتأسر العبيد في أفريقيا وتبيعهم في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية . ومن هنا يتضح أن الغرض من هذا ، على وجه التحديد ، هو الحفاظ على النظام العنصري وإعادة إنتاجه ، لتأمين امتيازات الغرب الاستعماري “البيض” بالكامل والحفاظ على تبعية باقي الشعوب و الأعراق لهم .
صحيح أن (جون لوك) أعلن في كتابه “مقالتان فِي الحُكومة” معارضته لـ “العبودية” ، لكن هذه “العبودية” كانت تشير في قناعته إلى تأييده الهيمنة السياسية للحاكم المطلق ، ويقدّم تبريراً للعبودية كنتيجة للحرب ، مستخدماً مصطلح “السلطة المطلقة” التي تمنح ملاّك العبيد سلطة على حياة وموت عبيدهم . في حين أن حجّته لا تتناسب مع العبودية الوراثية التي كانت تتشكّل في الولايات المتحدة والتي تم استشهاده بها لتبرير الممارسة العنصرية باصطياد العبيد في أفريقيا وبيعهم في أمريكا ، إذ لا يمكن تبرئة “فيلسوف الحرية المزعومة” هذا من دوره كمسؤول استعماري ومستثمر في تجارة الرقيق في شركة “رويال أفريكان” المملوكة للتاج البريطاني . فهو كان حريصاً بشكل أساسي على ” حرية وازدهار الإنكليز ولو تَمّ ذلك على حساب استعباد الأفارقة وبيعهم كسلعة رابحة ” .
وكذلك كان “فولتير” فيلسوف التنوير أو الفيلسوف التاجر ، كما يجب أن تكون صفته ، مستمراً في شركة الهند الشرقية الفرنسية ، التي تأسّست عام 1664 لاستغلال منتجات الأرض الجديدة (أمريكا) ، بما في ذلك الأفارقة الذين كان يتمّ شراؤهم وبيعهم كسلعة من أجل تحقيق الربح . فقد كانت كراهية (فولتير) الشديدة للمجموعات الدينية كافية للتحريض على العنف ضدّهم ، بينما أكّدت عنصريّته البيولوجية أن هناك تدرّجات لأشكال الحياة ، حيث صوّر أصحاب البشرة السوداء ، في “رسائل أمابيد” (1769)”حيوانات” ذات أنوف سوداء مسطّحة ، مع ذكاء قليل أو من دونه” .
كان (فولتير) ، إلى جانب (جون لوك و كانت) ، نموذجاً لفلاسفة التنوير الذين قدّموا تبريراتهم لكراهية الجماعات العرقية والدينية . وقد وضع (ايمانويل كانت) في عمله الأنثروبولوجي مخطّطاً أكثر رسمية للتراتبية العرقية ، حيث يقول :
“في البلدان الحارّة ، ينضج الإنسان مبكراً ولكنه لا يصل إلى كمال المناطق المعتدلة”.
وقد كشفت العنصرية الممنهجة عن الارتباط والدعم الوثيقين بين فلاسفة “التنوير” وبين الإمبرياليين الذين سعوا إلى قهر وقمع الأعراق بدعوى أنها أقل شأناً ، وأن “البشرية حقّقت كمالها الأعظم في العرق الأبيض ، وأن للهنود الصُّفْر موهبة أقل ، بينما يوجد الزنوج في مرتبة أقل بكثير ، وأن بعض شعوب أمريكا تحتل مرتبة أدنى”..
ويؤكّد على أن “البيض يمتلكون كل الدوافع الطبيعة في المشاعر والعواطف ، وفي جميع المواهب ، وكل الاستعدادات للثقافة والحضارة ويمكنهم بسهولة طاعة الحكم . ووحدهم من يتقدّمون دائماً نحو الكمال” .
لم يكن شرّ عصر التنوير هذا هامشياً في عمل هؤلاء الأيديولوجيين . فقد تمّت قراءة كتاباتهم على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا ، ولا سيما من قِبَل صديق (فولتير) ملك بروسيا (فريدريك الثاني) الذي دعاه إلى الانضمام إلى البلاط الملكي في “بوتسدام” ليكون مُرْشداً له في سياسته وفي إدارته لحكم بروسيا . وإن حرص المثقفين العرب على إيجاد التبريرات لإعفاء هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من كل مسؤولية عن الشرور والأخطاء القاتلة بحق الشعوب والناتجة من تحيّزاتهم العنصرية والاستعمارية بدعوى أنها صدرت عنهم في أزمنة “أقَلّ تَنْوِيراً” ليس في جوهره إلا حرصاً على شَرْعَنَة الاستعمار وتفوّق العرق الأبيض المزعوم على باقي الأعراق الأخرى لأجل إِدَامة استعبادها ونهب خيراتها المادية والرمزية ومحو هويتها القومية والثقافية .
وخير مثال على ذلك ماجاء في
طاعون (البير كامو) .. كرواية في
الفلسفة التنويرية .
إن رواية “الطاعون” هي من أهم روايات الكاتب والروائي والأديب التنويري و العبثي الفرنسي (البير كامو) ، الذي حصل على جائزة نوبل في الآداب وعمره 44 عاماً فقط . وهو الذي يعتبره الكثيرون من المثقفين العرب رمزاً ومدرسةً في “الفلسفة التنويرية” . فقد وُلِدَ عام 1913م في الجزائر وتوفي عام 1960م بحادث سير في باريس .
في رواية “الطاعون” يطرح (كامو) عدداً من الأسئلة الوجودية عن حال البشر وطبيعة القدر . ولأنه عاش في الجزائر ويحب الجزائر كأرض وبلد ولايحب الجزائريين الذين يتمنى اختفاءهم عن أرض الجزائر كلها ، فإنه يتحدَّث في روايته عن وباءِ “الطاعون” – كرمزٍ في وصف الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي – وهو يجتاح مدينة “وهران” الجزائرية في أربعينيات القرن الماضي . ويبدأ في تصوير “الجرذان” -الجزائرية – في مدينة “وهران” وهي تتساقط ميتةً في شوارع المدينة ، لتبدأ الهستيريا الجنونية في المدينة ، بعد أن نشرت الصحف أخبار الوباء . وبعد ضغوطٍ من أهالي المدينة – الفرنسيين – تستجيب السلطات بجمع الجرذان لإحراقها ، ليكون هذا سبباً في انتشار (الطاعون الدبلي) حيث يعيش الدكتور (برنار ريو) حياة هادئة يتخللها موت حارس المبنى نتيجة حمى غامضة . ليقوم بأبحاث يجريها مع صديقه (ميشيل) ويتوصلان إلى نتيجة تفيد بأن “الطاعون” يجتاح المدينة ، والذي يقصد به بزوغ الثورة الجزائرية ضد المختل الفرنسي ، لا تصدقه السلطات بحجة أنَّه لا توجد سوى حالة وفاة واحدة ، لكن سرعان ما يتزايد عدد الوفيات ، ويرسل الطبيب زوجته إلى مصحة بعيدة لأنها مصابة بمرض مزمن ، وبمرور ثلاثة أيام تصبح الأمور سيئة جدّاً ، حيث باتت المنازل أماكن حجرٍ صحي ، ولا تُدفن الجثث إلا بإشراف السلطات ، بإشارة إلى أن الوضع قد خرج عن السيطرة تماماً .
وبعد ذلك أُغلقَت المدينة رسمياً مع الإعلان عن تفشي “الطاعون” ، وفُرِض حظر السفر على الجميع ، وتوقفت خدمات البريد ليقتصر التواصل على الهاتف من أجل المكالمات الضرورية العاجلة ، حيث تؤثّر العزلة على سكان المدينة ونفسياتهم خوفاً على حياتهم وأملاكهم من ” الطاعون ” ، فيحاول بعض سكان المدينة الهروب منها ، ويستغل أحد رجال الدين الموقف لتعزيز مكانته الإرسالية والتبشيرية بإلقاء الخطب والمواعظ للتخلص من ذلك الوباء .
ورغم مرور عدة أشهر يستمر وضع المدينة بالتدهور ، ويحاول كثير من الناس الهروب من المدينة ، ولكنَّ العديد من المسلحين – الذين هم الثوار – يمنعونهم ويطلقون النار عليهم . ونتيجة ذلك تندلع أعمال العنف وعمليات النهب ، وتعلن السلطات الأحكام العرفية وحظر التجول ، وتصبح أعداد الوفيات ترتفع بشكل كبير ، وهذا ما يؤثِّر على مشاعر وعواطف الناس بشكل أكبر من ذي قبل .
وبحلول شهر سبتمبر تصل مدينة “وهران” إلى أسوأ حالاتها مع الطاعون ، كما أنَّ حالة زوجة الدكتور (ريو) تزداد سوءاً ، ولكنَّه يظلُّ قويًّا من أجل مواجهة “الطاعون” ، ويتوصل الدكتور (كاسيل) إلى مصل جديد يجري تجريبه على المرضى المصابين بالوباء ، فتبدأ أعداد ضحايا وباء “الطاعون” بالانخفاض .
ومع بداية شهر يناير يتراجع “الطاعون” كثيراً ، وحين تبدأ احتفالات الناس بانتهاء المرض ، تموت زوجة الدكتور (ريو) ويموت أناس آخرون كانوا قد ساعدوا المدينة في تجاوز تلك المحنة ، أمَّا المُهرِّب – الفرنسي الانتهازي – الذي استغلَّ المحنة في جمع المال فيفقد السيطرة على نفسه ويطلق النار على بيوت الناس وتلقي الشرطة القبض عليه . لتنتهي الرواية مع انتهاء ذلك الوباء “الطاعون) الذي كتب بداية الرحيل الفرنسي عن الجزائر .